التقاطب السياسي الدولي والصراع المذهبي والديني في المنطقة العربية والمغاربية

والعالم بعد هدم جدار برلين يعرف تطورات جديدة على مستوى تشكيل القوى السياسية والاقتصادية على أساس انبثاق تقاطبات جديدة، أصبحت أوضاع منطقة الشرق الأوسط تشكل انشغالا كونيا للدول ومختلف المنابر الإعلامية. إنها تطورات تفرض على المتتبعين، مغربيا، التحلي بنوع من اليقظة من خلال تجديد أرضية التفكير في مستجدات التطورات السياسية في العالم. إنه الخيار المناسب من أجل تثبيت المقومات الضرورية لتقوية العلاقات الخارجية ليتمكن المغرب، البلد الإفريقي والمغاربي الأكثر مناعة سياسيا، من تحقيق المقومات المطلوبة للمشاركة في التأثير إقليميا على مجريات الأحداث، وعلى رأسها الحسم النهائي في قضية الوحدة الوطنية، ومن تم أخذ المبادرة لبناء مجموعة اقتصادية مغاربية وعربية. وعندما أتحدث عن إشكالية التثبيت هاته، وما تتطلبه من مسؤولية فكرية وسياسية، نعني من خلال ذلك أن مسألة "الزمن أو الوقت"، وما تثيره من إشكاليات مرتبطة بالسياقات الجغرافية والزمنية، تجعل الشعوب الإقليمية في وضع لا ولن يحتمل المزيد من الغموض في الرؤية والفهم. لقد حان الوقت للمرور إلى مرحلة الدعاية للمشروع السياسي المغربي، بشقيه السياسي والثقافي، ليكون نظاما نموذجيا في مسألة الانفتاح على عصر الديمقراطية والحداثة والثورات التكنولوجية وتقنيات التواصل المتجددة. بالطبع، الاستعداد الكامل للدخول في مرحلة الدعاية لمشروع سياسي وطني، بأبعاد إقليمية وجهوية، هو في حقيقة الأمر مرتبط بمدى النجاح الذي ستحققه البلاد في سنتي 2016/2017، نجاح، يجب أن تكون فيه نسبة المشاركة السياسية مرتفعة بالشكل الذي يساهم في التضييق على هوامش دعوات الرجوع إلى الوراء النافية لتقدمية الآيات القرآنية، وعلى رواد استغلال الجماهير بخطابات لا يمكن إطلاقا أن يستوعبها العقل المستنير الغيور على الوضع المادي والمعنوي للشعوب والأمم. نقول هذا لأننا نؤمن أن الدخول في مرحلة الدعاية السالفة الذكر يتطلب استعدادا سياسيا ونضجا ثقافيا بطبيعة تقوي عزائم النخب المؤسساتية والمجتمعية للانخراط في المسايرة الفاعلة لركب التقدم العلمي والتكنولوجي. إن رفض الحاضر، كما هو شائع اليوم في الشرق الأوسط، وعدم الالتزام بالحوار السياسي الداخلي البناء لتطوير المشاهد السياسية، قد فتح الباب على مصراعيه للاقتتال والعنف والتكفير، والابتعاد كل البعد على مطامح المواطنين البسطاء. لقد رهنت القوى المتصارعة "المصطنعة" مصير منطقة الشرق الأوسط للمجهول ولمصالح القوى الدولية القوية. لقد عاشت المنطقة تطورات غريبة في طبيعتها ساهمت في "التبخيس" السريع الهدام للمجهود التراكمي الفكري الكبير الذي عرفته المنطقة وعلى رأس ذلك "فكر المستقبليات في الإسلام"، وهي الأساس في الدين، أساس عبر عنه المرحوم محمد عابر الجابري بالكليات الصالحة لأي زمان ومكان.
في سياق منطق إسهاماتنا الإعلامية، دعونا فيما سبق إلى التفكير في مسألة تقوية العلاقات العربية والمغاربية والفارسية والتركية بمنطق اقتصادي يضعف مع مرور الزمن النزعات المذهبية المرتبطة بتحقيق الغنائم غير المشروعة، وبالتالي بناء أرضية سياسية واقتصادية تحول القرار السياسي بالمنطقة إلى آلية لدعم الفكر الإنساني على المستوى الكوني. لقد سبق أن أشرنا في كتابات سابقة كذلك إلى كون حقوق الإنسان في الإسلام بكلياته لا تتعارض ومقومات الفكر الاشتراكي الديمقراطي، وأن فلسفة حقوق الإنسان تعلو على خصوصيات الشعوب، ولا يوجد أي تناقض بين فلسفة الغرب في هذا المجال والمبادئ العامة في الإسلام. فالمغرب، بخصوصيته، والذي نحج إلى حد مقبول نسبيا في تقوية مناعته أمام الصراعات المذهبية التي تأججت ما بعد الصراع التاريخي ما بين علي (ض) ومعاوية، نرى أنه مؤهل للإسهام في تحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ما بين الدول القوية في المنطقة وبالتالي عودة الهدوء إليها وتمكينها من المشاركة القوية في إعادة بناء الدول المتضررة بدعم دولي. لقد تبين أن فكرة التركيز على مسألة المد الإيديولوجي على أساس المذاهب العقائدية، سواء كانت شيعية (عند إيران) أو سنية عثمانية (عند تركيا) أو وهابية (عند السعودية)، قد أصبحت نقطة ضعف يستحيل من خلالها التفكير في تحويلها إلى مرتكز لتقوية دولة إقليمية على حساب أخرى، ليعيش شعب مسلم في وضعية رفاهية على حساب شعب مسلم آخر من نفس المنطقة. فعوض ضياع الوقت والجهد في ترويج هاته المعتقدات، ذات الطبيعة التاريخية التي لا تمت بعلاقة بمنطق خالق قانون الطبيعة (الله عز وجل)، وتحويله إلى أساس تتبلور من خلاله المخططات الجيوستراتيجية، أرى أن الوقت قد حان للتفكير في استغلال نقط القوة في التاريخ المشترك للمنطقة لخلق سوق جهوية اقتصادية يكون لها الموقع الدولي المناسب. وهنا ندعو القارئ للعودة إلى مقال سابق عنوناه "إيران، النهضة العربية والرهانات الجيوستراتيجية للقوى العظمى في منطقة الشرق الأوسط".
كما نرى في نفس السياق أنه من المفيد العودة إلى تاريخ الصراع الدولي على أساس القطبية ما قبل التسعينات، أي إلى المرحلة الحساسة لعهد كورباتشوف في الاتحاد السوفياتي. وهنا نفترض أن هذا الرئيس قد وجد صعوبة ومقاومة كبيرة في تلك المرحلة لخلق التحول في نظام الدولة السائد من خلال محاولاته لتفعيل مشروع "البروستروكا". لقد فتحت هذه المقاومة، الشرسة للمسار الإصلاحي الذي أعطى انطلاقته، الباب لبوريس إلتسين لمهاجمة البرلمان بالدبابات ومحاصرة القوى السياسية التي رفضت مغادرة مبنى السلطة التشريعية. لقد أعطى هذا الانقلاب فرصة لجيل جديد، بمنظور سياسي مختلف توج بوصول بوتين إلى الحكم، لتمكين روسيا من العودة من جديد إلى ساحة الصراع الدولي، مشكلة بذلك قطبا دوليا مع الصين الشعبية وبامتدادات إقليمية. والحالة هاته، وإذا ما اعتبرنا التطورات في روسيا ما هي إلا نتيجة مرتبطة أساسا بذكاء رواد الفعل السياسي بهذا البلد الطامحين إلى الوصول إلى هذه المرحلة، فإن وضع منطقة الشرق الأوسط يفرض على روادها كذلك إعادة حساباتهم السياسية. فلا يمكن، من باب مسؤولية الانتماء إلى هذه المنطقة العربية والمغاربية الإسلامية، أن تعيش الشعوب وضعية بدون قيادات وزعامات تقيها من احتمال خضوعها مجددا (في الألفية الثالثة) لمطامع القوى الأجنبية. إن القوى العالمية تتصارع كلها في إطار منطق سياسي جديد انتصر فيه الحق في التراكم الرأسمالي وفي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. من الأجدر، سياسيا وتاريخيا، أن تكون نخب منطقتنا هي السباقة إلى تحويل المعركة الإيديولوجية، التي وصلت إلى أوجها بعد إعلان انتصار التوجهات النيوليبرالية المدعمة للسيطرة المالية والاقتصادية للشركات العابرة للقارات والشركات متعددة الجنسيات (إلغاء كل الحواجز المعرقلة لحرية حركية السلع والخدمات ورؤوس الأموال مع فرض نظام انتقائي في مجال الهجرة ونقل الخبرات العلمية والتكنولوجيا)، إلى معركة سلمية دبلوماسية جديدة تربط الديمقراطية على الصعيد الكوني وعلى صعيد البلد الواحد بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والحرص على تقليص الهوة ما بين الأغنياء والفقراء وما بين الشمال والجنوب.
في نفس السياق، لقد سبق أن أشرنا أن الحسم في قضية فلسطين/إسرائيل لن يكون إلا بحل الدولتين، وأن تشويه صورة المعتقد بالمنطقة لا يجب أن يبقى مرتبطا على المدى المتوسط والبعيد بغنى المنطقة. فهناك سبل أخرى للتفاهم على مصادر الطاقة في الشرق الأوسط (سبل يجب أن تخضع لمبدأ رابح-رابح)، سبل يجب أن تساهم في تأسيس مقومات سياسية جديدة تحترم السيادة القطرية للدول وتستحضر حاجيات الشعوب للتنمية والازدهار. إنه السبيل الممكن لإخراج الملفات: العراقي والسوري والليبي واليمني من عنق الزجاجة.
إن استحضار عودة روسيا إلى الصراع الدولي، بآليات كان الرئيس كورباتشوف يريد الوصول إلى تطبيقها في عهده، واستحضار وضع ومكانة إيران في هذا الصراع والمعاناة الجديدة للنظامين التركي والسعودي (معاناة متفاوتة بطبيعتها وحدتها)، جعلتنا اليوم، كمتتبعين، نسعى إلى الوصول إلى إضفاء نوع من الوضوح على خبايا المنطق الدولي في التعامل مع حقوق ومستقبل شعوب المنطقة (لقد سبق لنا أن طرحنا للنقاش ثلاث فرضيات في هذا الموضوع). لقد أصبحنا نميل اليوم إلى اعتبار الهدف من تأجيج "العنف" على أساس نزعات عقائدية بالمنطقة، هو إيهام الشعوب تعسفا بروابطه الدينية، في وقت نعتبر فيه أن هذا الربط هو بمثابة ذرائع لإضفاء نوع من المشروعية للتدخلات الأجنبية وتأجيج الصراع فيما بينها على أساس اعتبار المنطقة مجالا جغرافيا عنيا بالطاقة ويقال أنه الأكثر ارتفاعا عن سطح البحر. وهذا المعطى لا يمكن أن يخفي عنا فرضية وجود نوع من التفاهم الضمني ما بين القوى السياسية في العالم في شأن التعاطي السياسي والاستراتيجي مع المنطقة. فبعد فتح المجال للمتطرفين بالدخول إلى تراب سوريا والعراق وليبيا قادمين من كل دول العالم لإسقاط نظام بشار الأسد، تم إعلان ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام وتمكنت من العتاد والسلاح لتحويل الصراع من طابعه السلمي إلى حرب هدامة، وتشكلت كذلك معارضة إسلامية إلى جانب هذا التنظيم الديني الجديد، وساد نوع من الخطاب في كل المنابر على المستوى الدولي في موضوع مواجهة القوى الإسلامية الجهادية في سوريا والعراق وليبيا والدعوة إلى الحيلولة دون تحولها إلى قوة استقلال في المنطقة (استئصال الإرهاب في مصدره). وطرحت كذلك في إحدى مراحل الصراع مسألة وحدة التيارات الإسلامية المعارضة والدعوة إلى توحيد الجيش المعارض تحت اسم «جيش محمد». كما عرفت العلاقات الدبلوماسية ما بين إيران والسعودية على إثر هذه الدعوة إلى التوحيد نوع من الانفراج، سرعان من شابه التوتر جراء التطورات في اليمن. فبعدما تم التصريح بعدم جدوى التدخل العسكري الغربي في سوريا، أدى استهداف فرنسا من طرف الإرهابيين لمرتين غير بعيدتين في الزمن، إلى التراجع على الفكرة. لقد تدخل الغرب وروسيا جويا في المنطقة، وتدخلت الدول العربية في اليمن. وتوج انتخاب الرئيس الإيراني الجديد (روحاني)، وما تلا ذلك من خطوات دبلوماسية، بإعطاء الانطباع وكأن العالم يتجه إلى التوافق في شأن تشكيل تحالف مصلحي جديد مدعم من طرف الغرب الأوروبي يضم كل من موسكو وبكين وواشنطن وتل أبيب وطهران، تحالف يدفع كذلك إلى افتراض كون الملف السوري، وما عرفته شعوب المنطقة من معاناة، هو في عمقه إستراتيجية غربية وروسية للكشف عن منابع الإرهاب وعزل الإرهابيين داخل سوريا، ومن تم "ضرب عصفورين بحجرة واحدة".
وفي الختام، علينا أن نتتبع، كمغاربة، تطور الأوضاع في المنطقة باستحضار مصلحة الشعوب العربية الشقيقة في النقاش السياسي والعلاقات الدبلوماسية. فلا يمكن للفاعلين المباشرين في الصراع أن يقبلوا مثلا اختزال الصراع في المنطقة منذ بدايته إلى نهايته في مجرد "أطماع" وخلق شروط التقارب لتوزيع مناطق النفوذ المصلحية ما بين الدول العظمى. فلا يمكن أن يستساغ أن يتوج الصراع اليوم بنوع من التوافق الأولي، في انتظار تطورات موازين القوى في كل من العراق واليمن، يجعل سوريا تابعة للنفوذ الروسي والصيني بامتداد قد يشمل لبنان وإيران (هنا يجب الإشارة أن الوضع السياسي في لبنان هو بمثابة ميزان الحرارة في تفاعل الصراع ما بين القوى الدولية والإقليمية)، وأن تكون ليبيا تابعة للنفوذ الغربي الأمريكي.، بامتداد يشمل دول الخليج.
بالطبع، الإيجابي بالنسبة لشعوب المنطقة هو بناء مجموعة اقتصادية بثقافة منفتحة على العالم بأسره. وهذا الهدف يبقى مرهونا بمدى تطور العلاقات الدبلوماسية ما بين الدول الفاعلة وعلى رأسها المغرب وإيران وتركيا والسعودية. لقد تتبعنا مبادرات سعودية وإيرانية وتركية لتجديد العلاقات الدبلوماسية فيما بينهم، علاقات يفترض أن تكون مدعمة بشكل سري من طرف الدول العربية، بحيث يكون الهدف المحتمل منها هو بناء مشروع استراتيجي عربي/شيعي وبناء جبهة شرق أوسطية عوض المشروع المحتمل الغربي/الإسرائيلي/الشيعي. وهنا نذكر بكلمة الرئيس التونسي المرزوقي، التي دعا من خلالها إيران إلى تغيير معاملاتها مع الدول العربية كدليل محتمل لوجود مثل هذه المبادرات. كما أن عامل القرب الجغرافي والتاريخ، والتوجه الإيراني الجديد، الذي تخلى مرحليا عن الرهان النووي المهدد لإسرائيل، يمكن أن يساهم في تعزيز الإرادة العربية في الاستعانة بالإمكانيات الإيرانية الضخمة من أجل بناء مشروع مشترك بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. فافتراض هذا الطموح لتقوية التقارب العربي-الإيراني-العثماني قد يعطي توجها جديدا لتطوير العلاقات الدبلوماسية بالشكل الذي يحافظ على التوازن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي افتراض إمكانية تثبيت تصالح دائم سني-شيعي. إنه الافتراض الذي سيحدث نوع من الاطمئنان لدى الغرب في شأن مصير "الدولة الإسرائيلية"، اطمئنان سيخفف العبء السياسي والمالي على الدول الغربية في بحثها عن الحلول الناجعة لحماية أمن إسرائيل والحفاظ على حصصها "المصلحية" بالمنطقة، لكن هذه المرة يجب مراعاة منطق "رابح-رابح" بالشكل الذي يحد من التلويح هنا وهناك بوجود "المشروع الصهيوني الكبير".
إذا ما تم إقرار إعطاء الأولوية للشعوب بالمنطقة، فإن التقارب العربي-الفارسي-العثماني يجب أن يكون في واقع الأمر أساسا للتقارب ما بين الغرب وروسيا والصين وليس العكس. إن ما تحتاجه اليوم هاته الشعوب هو تحقيق المصالحة الواعية ما بين التراث والحداثة في عقول الأفراد والجماعات، مصالحة يكون أساسها تعميم النقاش الفكري في التراث، ونقد أعطاب الثقافة السائدة، وتعميق التفكير والحفر في أسسها وأبنيتها العميقة، وبالتالي تثبيت المقومات التاريخية المشتركة وتحويلها إلى أساس لتقوية العلاقات الخارجية. إن مصداقية الدول العظمى في العالم مرتبطة اليوم بمدى استعدادها لدعم حاجة شعوب المنطقة إلى التحديث الثقافي على أساس ترسيخ نظرة شعبية جديدة تؤسس لعقل ونظام معرفي جديد يتطور في التاريخ وبالتاريخ. فالحضارات العربية والمغاربية والفارسية والعثمانية جد غنية بإبداعاتها واجتهاداتها، ويبقى من العيب أن نختزل رصيدها التاريخي في الدعوات إلى الرجوع إلى الوراء والتنكر لتراكمات الحضارة الإنسانية العلمية والفلسفية والتكنولوجية.... فملف التهجير القصري للشعوب من منطقة الشرق أوسطية إلى الشمال تتحمل مسؤوليته في المرتبة الأولى دول المنطقة وفي المرتبة الثانية الدول العظمى..... ومن شأن تقارب الأولى أن يساهم في تقارب الثانية، وبالتالي تقوية العلاقات الاقتصادية ما بين الشمال والجنوب من شأنه أن يجنب العالم اختزال حل الأزمات في بيع الأسلحة ومصادر الطاقة والمعادن النفيسة والمواد الفلاحية الخام والمواد الأولية .....
وعندما يتم الحديث عن تقارب دول المنطقة، نعني بذلك ضرورة تحقيق المصالحة ما بين الدين والسياسة بالشكل الذي يجعل الاستثمار في تحقيق الرفاهية المادية للشعوب من أولوية الأولويات. إنها الحاجة للابتعاد الثقافي عن استغلال الدين في السياسة وتحويل تأجيج الصراع العقائدي إلى عرقلة حقيقية للنماء المادي للشعوب والأمم. وهنا لا بد أن تستحضر دول المنطقة التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب، ملكا وشعبا، لتحقيق هاته المصالحة الداعمة للتطور الديمقراطي لبلادنا.... مصالحة من المنتظر أن تتقوى بعد إجراء الاستحقاقات البرلمانية المقبلة....
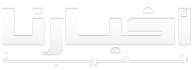


















هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟