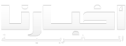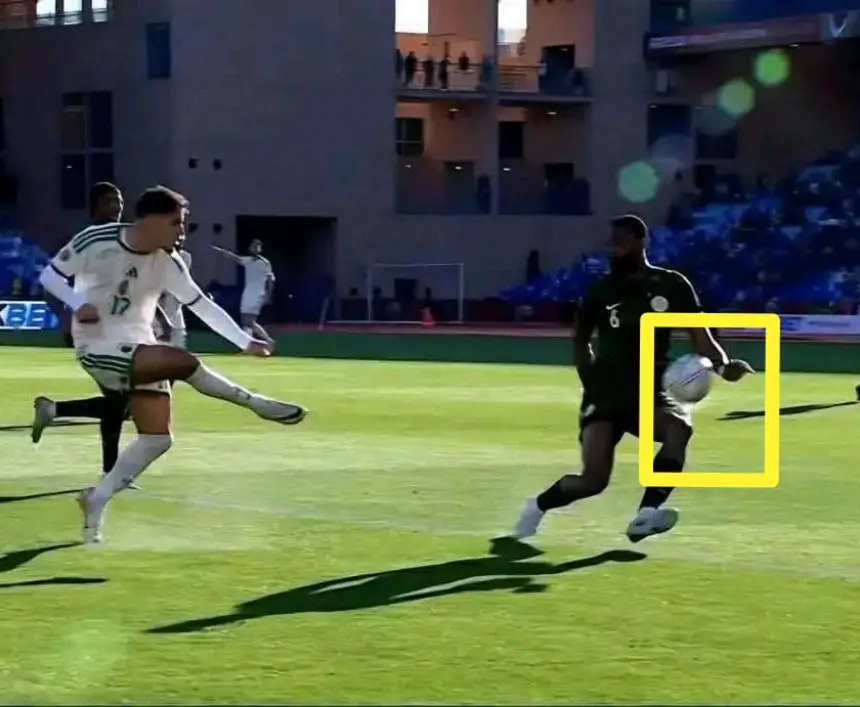الدستور الجديد : رقص على إيقاع خرافة التغيير

بوشحموض ماء العينين
مما لا شك فيه أن إقرار الدستور الجديد للمغرب سنة 2011 جاء استجابة لمطالب حركة 20 فبراير الفتية و بعض الأحزاب الراديكالية ، فالفضل يعود لهذا الائتلاف الذي وضع الإصلاح الدستوري على الأجندة السياسية و استطاع أن يفرضه على الملك الذي تجنبه منذ توليه العرش إلى أن بدأت رياح الربيع الديمقراطي تهب عليه في عقر حِصنه .لكن التساؤلات التي أصبحت رهينة الطرح هي :
- هل الإصلاح الدستوري ارتكز على أسس البناء الديمقراطي ؟
- هل التنصيص الدستوري يتلاءم و المشروعية الديمقراطية لإقرار دولة الحق و القانون و الحريات ؟
يعتبر كل دستور جديد لحظة أساسية في حياة الشعوب ، لكونه يجسد طموحاتهم في إقامة دولة القانون والحريات و الاعتراف به كمصدر للسلطة و السيادة ، ويقرر مصيره السياسي عبر إنتخابات حرة و نزيهة في إطار الضمانات الكافية تجاه أي تدخل أو تعسف أو استبداد للسلطة .لذلك اتسم "الإستتناء المغربي" بتعيين الملك للجنة صياغة الدستور في خطاب 9 مارس 2011 تعمل تحث إمرته رغم معارضة الحركة الفبريرية، ومطالبتها بانتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور على السكة الصحيحة ، لتجد هناك عدة سكك تقود إلى توجهات عديدة حسب ميزان القوى و ليس حسب إرادة سياسية حقيقة للإصلاح ، وفي 17 يونيو من نفس السنة أطل علينا الملك من برجه العاجي مرتجفا يقدم مضامين التنصيص الدستوري و يجند الدعاية العمومية ( المؤسسات الأمنية و الدستورية و الدينية و الإعلامية...) للتصويت بنعم للدستور الذي لا يختلف في الجوهر عن دستور 1996 إلى في النقط التالية و المقيدة بدورها :
- دسترة اللغة الأمازيغية .
- دسترة كافة حقوق الإنسان .
- الإنبتاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية ( رئيس الحكومة من الحزب المصدر للانتخابات ).
- دسترة المؤسسات .
إن هذا النص الجديد يقوم على نوع من التحايل القانوني (الإيحاءات اللغوية) بإرفاق التنصيص على الحقوق بشروط مرهقة تجعل ممارسة هذه الحقوق شبه مستحيلة ،علاوة على تراكم الرئاسيات لدى الملك "برلمانيا ،وزاريا، عسكريا، أمنيا، دينيا،..."وبالتالي يوجه مسار السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية والسلطة الرابعة ، كما له الحق في أي تغيير دستوري لا غير حيث أخضعت الصلاحية البرلمانية لشروط معقدة ضدا على قواعد الشرعية الدستورية و مأسسة الدولة ومبدأ فصل السلط وكل قواعد الخيار الديمقراطي . لكن إلحاح القوى الديمقراطية على عصرنة الحكم المخزني و إيمانها بالسيادة الشعبية كحكم أسمى بين المؤسسات عبر صناديق الاقتراع دفعها إلى مقاطعت استفتاء 1 يوليوز 2011 و رفضت التطبيع مع النظام على حساب البؤساء و المحرومين من أبناء شعبنا، وخلو النص الدستوري من التنصيص الواضح و الأمين على ثلاث مرتكزات أساسية في البناء الديمقراطي :
1- سمو المواثيق الدولية كتشريعات لحقوق الإنسان الكونية بدون شروط تهدر جوهر هذه الحقوق.
2- إخضاع الأجهزة الأمنية و العسكرية للإشراف الحكومي و المراقبة البرلمانية .
3- الدولة المدنية و حرية المعتقد: أي الطابع المدني للدولة يعني اعتبار الشعب مصدر السلطة لبناء مجتمع ديمقراطي و حداثي يشكل تحصينا كبيرا و صمام أمان ضد استغلال الدين و الضمير لتنميط الشأن العام .
فالدستور الحالي هو دستور برنامج يؤطر مختلف المؤسسات من أجل ضمان و خدمة الملكية الحاكمة و استمرار هيمنتها على السلطة أمام تجاهل المطالب الإستراتيجية للمجتمع المدني و غياب الضمانات الواضحة في القانون، الذي يتم اختراقه لوجود تناقضات و بياض في عدد من مقتضياته إضافة إلى تفشي الزبونية و المحسوبية .و بالتالي لا يتلاءم و المشروعية الديمقراطية لإقرار دولة الحق و القانون و المساواة .
إن دستور 2011 نص وضع على عجل ، وفي جو طبعه الجري اللاهت خلف محاولة إطفاء جذور حركة 20 فبراير و الاحتقان على جميع الأصعدة .فمناصريه يتحدثون عن تنزيل الدستور و أجرأته فهل ينتظر من القردة أن تلد الغزلان؟ فما هو إلا وهم للتغيير لا يستوفي شروط الانتماء إلى نادي الملكيات الديمقراطية "الملكية البرلمانية" ،ولا يُخرِج النظام السياسي المغربي من خانة الملكيات المطلقة المغلفة بالدين المُؤَدلج خدمتا للريع المخزني، أمام تغييب الإرادة الشعبية و فصل السلط و توزيع عادل للثروة .فنحن مثل جميع شعوب الأرض نستحق ديمقراطية كاملة ، بلا إبطال أو تسويف حيث لم يعد مقبولا أن يتكرم علينا الطاغية بفتات الديمقراطية فكل الديمقراطية هنا و الآن .