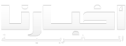تعثر الانتقال الديمقراطي مسؤولية من ؟

رشيد العزوزي
لم يعد يفصلنا إلا أيام معدودات عن الانتخابات التشريعية المزمع إجرائها في 7 أكتوبر 2016، حتى يعرف الشعب المغربي من سيتولى مشاركة الملك في حكمه خلال الخمس سنوات المقبلة،على أمل أن تكون مرة أخرى مناسبة تاريخية لتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي، المنشود منذ أكثر من نصف قرن .
نظريا يعد موضوع الانتقال الديمقراطي مبحثا رئيسيا في علم السياسة منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين، يهتم بالأسباب والمدخلات، والطرق والأنماط، و النتائج والمخرجات وغيرها .
وطنيا على مدى العقود السبع الماضية اشتد الحديث في الأوساط السياسية منذ أول حكومة بعد الاستقلال برئاسة لهبيل مبارك البكاي 1955-1956، إلى رابع حكومة في تاريخ استقلال المغرب برئاسة عبد الله إبراهيم 1958-1960، وصولا إلى حكومة التناوب بقيادة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، التي علق عليها الشعب المغربي آمال لا مست عنان السماء تماما كما راهن فئات عريضة على حكومة ابن كيران .
الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب المستقل التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بصفة رئاسة الحكومة لا الوزارة الأولى ، تمتعت بصلاحيات فاقت سابقيها، جاءت في سياق خاص تمثل في وصول رياح الربيع العربي إلينا، فامتلأت الساحات، وظهرت حركة عشرين فبراير، فأثمر الحراك الشبابي دستور 2011 ، الذي قيل عنه أنه ديمقراطي كما قيل عنه أنه ممنوح ولا يشجع على تحقق الانتقال .
منذ أول حكومة إلى غاية خط هذه السطور والمعارضة والسلطة التنفيذية والإعلام والمفكرون والباحثون المغاربة والمهتمون، كما عموم المواطنون يتحدثون عن هذا الانتقال الموعود، ولا سيما كلما اقترب موعد انتخابي، وكأنها القيامة كما قال جلالة الملك في خطابه الأخير، الكل يحاضر في السياسة، يعد، ويرى في نفسه البديل والمهدي المنتظر العائد في اعتقاد الشيعة لا محال بعد غيبة، أو السيد المسيح النازل من السماء، ولا أحد يقدم نفسه كبرنامج سياسي مستعد للمحاسبة، لذلك يبدو أن الطريق وعر وشاق وطويل لأسباب عدة يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي، والداخلي بالخارجي، والسياسي بالاقتصادي.
أيام قلائل تفصلنا عن هذه الانتخابات، التي تعد شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية وليست كل الديمقراطية كما تعتقد مجموعة من الدول التي تعيش مخاض الانتقال كالمغرب، لتتناسل معها أسئلة قديمة حديثة من قبيل .
هل هي أزمة أحزاب سياسية أغلبها لا زال يجهل أدواره الوظيفية، ويعيش انحرافات جمة في الفهم والممارسة ؟ أم هي أزمة نخب ؟ أم المشكل في النظام السياسي برمته ؟ هل فعلا نحن واحة ديمقراطية واستثناء وبالتالي عن أي انتقال نتحدث جميعا؟ هل الدستور الحالي بعد أن تشربنا معانيه، يكفي تنزيله فقط وسنقطع مع اللا ديمقراطية ؟ كم يلزمنا من الوقت لنضع حدا للإقطاع السياسي وما تبقى من الأوليكارشية، ونعيش الديمقراطية والعدالة الاجتماعية حقيقة كما هو متعارف عليها، وليس على مقاسنا بدعوى التدرج تارة و الخصوصية والمسلسل الانتقالي أخرى ؟
لن ندعي الإجابة عن كل هذه الأسئلة، ولن نقول السؤال أهم من الإجابة في هكذا مناسبة سياسية لا فلسفية، لكن دون شك نستطيع القول أن الدولة مع النخب السياسية تبقى مسئولا بارزا في قضية لا عبوها كثر.
للحقيقة والتاريخ هناك من يرى غياب إرادة حقيقية لوضع لبنات أولى لدولة ديمقراطية مغربية عصرية منذ أول فرصة ذهبية، ومع شخص من طينة الكبار هو عبد الله إبراهيم، الذي لا يستطيع أحد من خصومه قبل رفاقه المزايدة على وطنيته ورؤيته المتبصرة، ومعها أجهض مشروعه السوسيو اقتصادي والاستراتجي الطموح، مشروع القطع مع الاستعمار بكافة أشكاله، مشروع مغرب الشباب والمقاومين والنقابيين، على عكس حكومة بلفريج التي يمكن اعتبارها امتدادا لتيار لا يساير هذا الطرح أو في أحسن الأحوال يتحفظ على كثير من نقاطه ومفاهيمه ومنهجيته.
حكم المشمول برحمة الله الحسن الثاني لوحده 1961-1963 للحفاظ على سير الدولة كما عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة، طفت فيها إلى السطح مجموعة من المشاكل الجوهرية بين القصر والمعارضة، المتمثلة في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي سيحمل اسم الاتحاد الاشتراكي ابتدءا من سنة 1975، والتي لم يكن رفض رفاق الزعيم المهدي ابن بركة ارتداء الزي التقليدي المتمثل في الشاشية والطربوش الأحمر أثناء افتتاح دورة من دورات البرلمان إلا أحد تجليتها البسيطة لأنهم رأو فيها رمزا من رموز العبودية كما رأى فيها المغفور له الحسن الثاني عصيانا وأمورا أخرى.
هذه المرحلة الأكثر حساسية في تاريخ المغرب المعاصر، والتي شهدت شدا وجذبا بين مكونات الحقل السياسي المغربي،عرف فيها المغرب عدة دساتير في أزمنة متقاربة جدا ( 1962- 1970- 1972-1992-1996) لكن يبقى الدستور الأول المؤسس الأساس لباقي دساتير المملكة، والذي اعتبره العديد من فقهاء القانون الدستوري متقدم في كثير من الجوانب بالمقارنة مع الدساتير السالفة الذكر بما فيها ستور2011، وهو ما يحتج به كل من يرى أن الأزمة أزمة نخب، لا قوانين وتشريعات.
النخب السياسية المغربية منقسمة على ثلاث، جزء منها وطني امن بقواعد اللعبة وانخرط في المعركة السياسية وصارع طواحين الهواء مااستطاع أو عارض معارضة مسئولة، وفئة أخرى انتهازية هي الكثيرة حسب المتبعين، لا يهمها إلا مصالحها الخاصة، والحفاظ على مكتسباتها الاجتماعية والشخصية الضيقة، التي تتعارض مع الإرادة الشعبية في كثير من الأحيان، بينما أخرى اختارت العيش في برجها العاجي حتى لا تفقد بريقها الفكري أو طهرا نيتها، أو لأنها لا تملك الإرادة الكافية .
الإرادة السياسة في تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي في البلاد وترسيخ دولة الحق والقانون، كانت مغيبة عند القصر في سنوات مضت كما يرى العديد من الباحثين، وضاع جهد كبير كان بالإمكان أن يسخر لصالح الدمقرطة في صراعات بين القصر والمعارضة الاستقلالية والاتحادية، فيما بعد انتهى بالانخراط التام للجميع والتفاهم على أرضية مشتركة قدم فيها الجميع تنازلات فحكم الاستقلاليون كما حكم الاتحاديون وحكم غيرهم.
في العهد الجديد هناك إشارات قوية من طرف جلالة الملك محمد السادس على ضرورة بدء صفحة جديدة، عبر عنها في أكثر من خطاب في المحافل الدولية كانت قريبة إلى خطابات رموز يسارية عالمية، في حين كانت الخطب الموجهة إلى الداخل ميكرو سياسية متصالحة مع واقعها الاقتصادي والاجتماعي وليست متعالية عليه، تحدث فيها عن التوزيع العادل للثروة وأزبال بعض المدن، وسكان أعالي الجبال، كما ذكر المشاريع الكبرى التي ربحت المملكة رهانها كالطاقات المتجددة وصناعة السيارات والطائرات ..فهل ستلتقط النخب الإشارة ؟