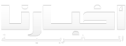قراءة في المشهد الحزبي المغربي عشية الانتخابات البرلمانية

عبد اللطيف الركيك
تستوقف المتأمل في المشهد الحزبي ببلادنا مع دنو أجل الاستحقاق الانتخابي جملة ملاحظات عامة نستحضر على ضوئها بعض التفاصيل الصغيرة:
-أولا: ثمة عدد كبير من الأحزاب يوحي لأول وهلة بأننا بإزاء قاعدة انتخابية تعد بمئات ملايين الناخبين وليس بضع ملايين، فهناك أحزاب لا تبرر وجودها أية حاجات مجتمعية، وإنما هي في واقع الأمر مجرد بنى وهياكل وهمية خُلقت خلقا من عدم، أو أملتها انشقاقات انتهازية ناتجة بالأساس عن افتراق المصالح الشخصية داخل الكيان الحزبي الأصلي.
-ثانيا: يلاحظ انعدام أي أساس فكري أو هوية إيديولوجية للكثير من القوى السياسية التي لا نعرف بالضبط من تمثل، وما أساس وجودها وما حقيقة مشروعها المجتمعي، أو برنامجها الانتخابي الذي لا يتعدى مجرد جمل إنشائية فارغة المحتوى ولا صلة لها بالتدبير الحكومي وبالواقع الاقتصادي للبلاد. إنها تتبدى على شكل إشهار انتخابي ونوع من الماركوتينغ الموسمي للاستقطاب وجذب الناخبين لا أقل ولا أكثر.
-ثالثا: غياب مشاريع مجتمعية أصيلة وواضحة ومتمايزة مسنودة إلى أفق فكري معروف، فالمشروع الوحيد الحقيقي غير المصرح به للكثير من أحزابنا هو الوصول إلى المناصب الذي تغذيه أطماع التربع على عروش الوزارات والنفوذ وتقاسم عائدات الريع والانتفاع الشخصي وتحوز الثروة ومراكمة المزيد من الامتيازات والمصالح والاقتراب من دوائر القرار.
رابعا: انعدام قواعد اجتماعية جماهيرية حقيقية لمعظم الأحزاب، فأحزابنا مقطوعة الصلة بأعرض فئات المجتمع، وهي تكتفي بمناسبة "الحضرة" الانتخابية بتحريك بعض ممن يمكن تسميتهم مجازا ب"المناضلين" وواقعا ب"الشناقة" الذين تتم الاستعانة بهم لتعبئة الطابور الخامس الذي يتموقع كزاد انتخابي قار، والطابور الخامس يتشكل عندنا من فئتان: فئة أولى من الأعيان وطلاب المصالح والانتفاعيين المحليين، وفئة ثانية من قاع المجتمع
ترزح تحت نير الفقر. وثمة علاقة جدلية بين الفئتين، فالأولى المتعطشة لمراكمة الثروة وحمايتها عن طريق التواجد في البرلمان هي من تستطيع التأثير على الفئة الثانية وتحريكها وتسخيرها للانخراط في العملية الانتخابية عن طريق توظيف وسائل الإغراء وتقديم الوعود الكاذبة، وهي الوعود التي لم يتحقق منها شيء بالرغم من ترديدها على الأسماع طيلة ما يربو عن أربعين سنة، ومع ذلك فإنها لا تزال تحتفظ بقوة الإغراء في أوساط الفئة الثانية. وتستفيد الفئة الأولى من حاجة الفئة الثانية ومعاناتها ومن ضعف دخلها وضعف ذاكرتها وضعف زادها السياسي والثقافي، وربما ضعف كل شيء، فهي-والحالة هاته-تسعى للظفر ولو بالنذر اليسير من الريع الذي تجود به مناسبة الانتخابات.
-خامسا: غياب التحالفات القبلية، فجميع الأحزاب تقريبا تصرح بأن الحديث عن التحالفات لن يكون إلا بعد صدور نتائج الانتخابات، وهذا له مغزى ومعنى ليس أقله أن أحزابنا لا تعرف أين تسير أو لا تستطيع السير بمفردها دون تلقي إشارات. علما بأن المعمول به في التجارب الديمقراطية الأصيلة هو حصول تحالفات قبل انطلاق التنافس الانتخابي لأن الأمر يتعلق بتدبير حكومي في الأفق وليس باقتسام كعكة انتخابية. إن هذا النوع من التحالفات ينبني بالأساس على انتماءات فكرية إيديولوجية ومشاريع مجتمعية وبرامج انتخابية تغيب للأسف في واقعنا الحزبي.
بعد عرض هذه الملاحظات العامة، يجدر بنا التأمل قليلا في واقع أحزابنا مع اقتراب موعد الانتخابات. وهكذا يرتسم المشهد الحزبي عشية الاستحقاق البرلماني في منظر تراجيدي يدعو للكثير من التأمل، ويسبب الكثير من الإحباط. فلأول مرة ربما في تاريخ تجربتنا الحزبية، لا نستطيع التفريق بين قوى سياسية متمايزة، كما لا نعرف من يوالي ومن يعارض. وبالمختصر المفيد يبدو المشهد المترهل كالتالي:
أولا: أن كبيرهم-الذي صار كبيرهم-ذلك المخلوق الحزبي الغريب الأطوار الذي انتقل بسرعة الضوء وفي سابقة من نوعها من المرحلة الجنينية إلى طور النضج الكامل والهيمنة المطبقة متعديا نواميس الطبيعة السياسية، لدرجة بات يمثل معها "بعبعا" يؤرق
الجميع بسب غموض قصة التأسيس، والتباس الحاجة السياسية والاجتماعية من وجوده، وغموض علاقته بدواليب الدولة.
ثانيا: وجود قوى سياسية ذيلية لا محل لها من الإعراب السياسي، كقوى تابعة لا تشكل قيمة مضافة ولا باعث لوجودها أصلا. وتتشكل هذه الحوانيت الحزبية من بقايا الأحزاب الإدارية التي خلقتها السلطة على فترات متباعدة، وهي دكاكين يكون من الأجدر-ظاهرا-وترسيخا للانتقال الديمقراطي الحقيقي إغلاقها وتشميعها من طرف الجهة التي أوحت بخلقها، لأنها ببساطة لم تعد تساير الواقع السياسي الراهن. بيد أن عمق الأشياء يشي بأنها لا تزال تضطلع بأدوار ليس أقلها توظيفها لتشكيل أغلبيات حكومية أو تسخيرها لتعطيل تشكيل تلك الأغلبيات.
ثالثا: بالنسبة للأحزاب التاريخية، فقد أصبحت قمينة بالفعل بهذا اللقب، فهي اسم على مسمى، ففضلا عن أنه لم يعد لها حاضر فبالأحرى مستقبل، فقد تحولت إلى كيانات حزبية متجاوز وتنتمي إلى الماضي، أي إلى التاريخ كما يوحي بذلك اصطلاح تصنيفها. فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي طالما تغنى بكونه تقريبا الوحيد الذي يتوفر على قاعدة مجتمعية حقيقية قوامها الطبقة الوسطى والفئات الدنيا في المجتمع، استحال بعد سلسلة من التفككات المتوالية إلى كيان ممسوخ فاقد لقاعدته ولهويته الأصيلة، حتى أن ذكر اسمه لا يكون إلا ممزوجا بمشاعر الإحباط والأسى لما آل إليه هذا الأفق الفكري التقدمي من هوان وضعف وتفكك، وذلك بحكم تضاد نصاعة الماضي مع كارثية الحاضر وضبابية المستقبل. أما الحزب الشيوعي قديما-ويا حسرة على الشيوعية-فقد تحول إلى مجرد "بيدق" لملأ الفراغ. وفي المقابل، فأن الحزب الاشتراكي الموحد قد اختار عن طواعية الطلاق مع سياسة المقاطعة والتركيز على الاستقطاب وتوسيع مده الجماهيري الذي كان يسير على أحسن حال، وارتمى في أتون اللعبة الانتخابية، وهو يعلم علم اليقين بأنه ذاهب إلى مقتله، بحكم أن الانتخابات عندنا تجري وفق ظروف معقدة تتسم بسيطرة الأعيان والولاءات القبلية والمناطقية لا على أساس الأفكار الغارقة في التجريد التي قد يتفنن الاشتراكيون في تدبيجها، والتي ربما ستبدو كمجرد سلعة بائرة لن تجد من يقبل عليها أو يلتفت إليها أو حتى
يهتم لأمرها عندما يشتد وطيس الحملة الانتخابية. إن الأفكار مهما كانت نيّرة أو براقة لن تصمد قطعا أمام وسائل الاستقطاب الأخرى، ولربما الاصطدام بواقع بهذا القدر من البشاعة هو ما سوف يستفيق عليه معشر الاشتراكيين الحالمين. إن المرتبة الأخيرة من ضمن قائمة "المتوجين" انتخابيا هي حتما بانتظار هذا الهيكل الحزبي الذي يمثل آخر ما تبقى من زمن المبادئ.
يبقى حزب الاستقلال الحزب التقليدي الوحيد الذي تمنّع على مسلسل الاختراقات، واستطاع نسبيا تحصين بنياته الداخلية من عواصف الانشقاقات الهوجاء. غير أن هذا الحزب المحافظ تقليديا لم يفتقد وهجه وتميزه في الساحة السياسية فحسب نتيجة المتغيرات التي حصلت في المجتمع وفي المشهد الحزبي الوطني، بل أكثر من ذلك استحال إلى مجرد رقم من ضمن الأرقام التي نستعملها لعدّ قائمة أحزابنا الطويلة. كما أنه لم يعد بمقدور الحزب العيش على تحريك التاريخ للإغتراف من المعين الانتخابي، فضلا عن أن سياسة التسابق على الأعيان التي بدأ ينتهجها لم تعد مجدية بحكم المنافسة الشديدة على أفراد معينين مع القوى السياسية الأخرى. وبالمحصلة، فإن حزب الاستقلال قد فقد تموقعه الجيد في مشهد حزبي ليست له ملامح واضحة، وهو التموقع الذي أتاحه له سابقا ذلك الزحم السياسي والاجتماعي الذي رافق انخراطه في الكتلة خلال بداية التسعينات من القرن الماضي.